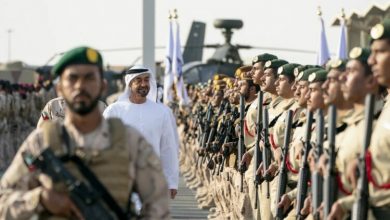ابتزاز أوروبي صارخ في مكافحة الهجرة

تسلط المطاردة التي يواجهها المهاجرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، والذين يتعرّضون للوصم منذ فبراير/شباط بسبب الخطابات الرسمية لأعلى هرم في السلطة، الضوء مرة أخرى على تدفق هؤلاء المهاجرين إلى هذا البلد المغاربي، فضلا عن كونه فتح الباب على مصراعيه لخطاب عنصري.
وصارت مدينة صفاقس، وهي العاصمة الاقتصادية للبلاد (270 كم جنوب تونس)، على وجه الخصوص محط الاهتمام.
تساءل الرئيس التونسي قيس سعيّد علانية عن “اختيار” مهاجري جنوب الصحراء التمركز في صفاقس، تاركًا كالمعتاد انطباعًا بأن هناك مؤامرة تٌحاك.
في الواقع، وحتى قبل أن تصبح صفاقس منطقة مغادرة نحو أوروبا، فإن التفسير يكمن في الديناميكية الاقتصادية النسبية لهذه المدينة، وطبيعة نسيجها الصناعي المتشكل من شركات عائلية صغيرة.
وقد وجدت هذه الشركات في بداية سنوات الألفين، فرصة لتحقيق الربحية بتوظيف مهاجرين من جنوب الصحراء، كونهم أقل تكلفة وأكثر مرونة، كما أنهم يقبلون التوظيف ظرفيا.
في منتصف العقد الأول من هذه الألفية، استفاد العمال من تسامح الدولة، فهي على كونها بوليسية كانت حريصة على استدامة قطاع تصديري صار إحدى واجهاتها.
الشجرة التي لا تخفي الغابة
يدفع التركيز على وجود المهاجرين من جنوب الصحراء إلى حجب واقع يُعدّ تطوره ذو دلالة أهم بكثير. فقد عرف مشهد الهجرة والوضع الاجتماعي التونسي تغيّرًا جذريًّا.
وانفجر عدد التونسيين الذين غادروا البلاد بشكل غير قانوني، مما جعلهم على رأس المجموعات المتجهة إلى أوروبا، إلى جانب السوريين والأفغان، وهو ما تشهد عليه آخر الإحصائيات.
وهكذا تصبح تونس، بالتناسب مع عدد سكانها، وإلى حدّ بعيد، على رأس الدول “المصدّرة” – إن جاز التعبير – للمهاجرين “غير الشرعيين”، مما يعطي صورة واضحة للأزمة التي تغرق فيها البلاد.
بالفعل، على طريقي الهجرة الرئيسيين – البلقان ووسط البحر الأبيض المتوسط، واللذان يمثلان قرابة 80٪ من التدفقات مع حوالي 250 ألف مهاجر غير نظامي من إجمالي 320 ألف -، نجد التونسيين من بين الجنسيات الأولى، مع السوريين والأفغان والأتراك على الطريق الأول.
ونجدهم في المرتبة الثانية، بعد المصريين وقبل البنغال والسوريين، على الطريق الثاني.
هذا الوضع ليس بجديد. فبين سنتي 2000 و2004 اللتين تضاعفت خلالهما عمليات العبور غير النظامية، كان عدد المغربيين وحدهم أكبر بإحدى عشرة مرة من عدد المهاجرين الأفارقة الآخرين مجتمعين.
ويأتي الجزائريون، الذين كانوا أقل عددا بعشر مرات من جيرانهم، في المرتبة الثانية. وعندما تعززت مراقبة السواحل الإسبانية، تحولت الهجرات غير النظامية نحو جنوب إيطاليا، لكن نفس التوزيع استمر.
وهكذا، في عامي 2006 و2008، وهما عامان شهدا ذروة الإنزال في صقلية، كان معظم المهاجرين (قرابة 80٪) من شمال إفريقيا (المغربيين وحدهم كانوا يمثّلون 40٪ من المجموع)، يليهم الشرق-أوسطيون، في حين تبقى نسبة مواطني دول جنوب الصحراء ضئيلة.
بات الأمر أكثر صحة اليوم. على مستوى البلدان المغاربية الثلاثة، فإن الهجرة غير النظامية للمواطنين تتجاوز بكثير هجرة مواطني إفريقيا جنوب الصحراء، التي تسلّط عليها الأنظمة الضوء، بل وتبالغ في تقديرها، لإخفاء هجرة مواطنيها وما تبوح به عن فشل سياساتها.
وهكذا، لا يظهر مواطنو جنوب الصحراء في مقدمة أي من الطرق من المغرب الكبير، سواء من تونس وليبيا أو على طريق غرب البحر الأبيض المتوسط (المغادرة من الجزائر والمغرب)، حيث يأتي الجزء الأكبر من المهاجرين من هذين البلدين ومن سوريا.
كما نجد مهاجرين من جنوب الصحراء بأعداد كبيرة – وحتى هنا يظلّون أقلّ عددا من المغربيين – فقط على ما يسمى بطريق غرب إفريقيا (الذي يشمل المغادرة من ساحل المحيط الأطلسي لموريتانيا والصحراء الغربية).
التفاوض على ريع جيوسياسي
شهد عام 2022 أكبر زيادة في عدد المهاجرين “غير الشرعيين” إلى أوروبا منذ عام 2016.
كما أنها السنة التي أصبح فيها التونسيون ضمن الجنسيات الأولى في حركة الهجرة هذه، على الرغم من أن عدد سكان البلد أقلّ بكثير من عدد الجنسيات الأخرى، السورية أو الأفغانية، والتي تشترك مع تونس في هذا الرقم القياسي المشؤوم.
لذلك، ليس من قبيل الصدفة أن يهاجم الرئيس التونسي المهاجرين من جنوب الصحراء في وقت تمرّ فيه بلاده بأزمة سياسية واقتصادية تتسبب في مغادرة التونسيين بنسب غير مسبوقة.
فالأمر يتعلّق بإخفاء حجم الكارثة. وعلاوة على ذلك، فإن الزعماء المغاربيين يقدّمون أنفسهم كضحايا حتى يجعلوا من وجود المهاجرين من جنوب الصحراء وسيلة للضغط من أجل التفاوض على ريع جيوسياسي لحماية أوروبا وتجنّب الانتقادات.
وقد جعل المغرب من هذه السياسة أداة في حربه الدبلوماسية على إسبانيا – مستنسخا ما قام به الزعيم الليبي معمر القذافي قبل عشرين عاما مع إيطاليا للتفاوض على إعادة إدماجه في المجتمع الدولي-، وشجّع على المغادرة نحو شبه الجزيرة الإيبيرية إلى أن اصطفّت مدريد أخيرًا إلى جانب أطروحات المملكة فيما يتعلّق بالصحراء الغربية.
كما يسعى التشدّد القومي المتطرّف الذي يشهده المغرب الكبير، والذي يمزج بين كراهية الدولة للأجانب التي تستهدف المهاجرين والمزايدات الشعبوية في تحدّي أوروبا، أن يجعل من قضية الهجرة رمزًا جديدًا للسيادة، مع التضحية بمواطني جنوب الصحراء ككباش فداء.
إنكار للواقع
عندما يتعيّن عليها تبرير قمع هؤلاء المهاجرين، تتحدث الأنظمة المغاربية عن “تدفق” و “جحافل” و “غزو”. كما تُبرز بإصرار ظاهرة التسول، ولا سيما تسوّل الأطفال.
وهي صورة بليغة بالنسبة إلى العديد من سكان شمال إفريقيا، لأنها الأكثر ظهورًا، كما قد يضايقهم التسوّل أحيانًا، فيثير الانزعاج ويغذي الخطاب العنصري.
تخفي هذه الصورة-الفزّاعة هذه حقيقة هجرة عمالة كبيرة، عرفت من خلال اللعب على التكامل أن تجد لنفسها ارتكازات في الاقتصادات المحلية، وسمحت بنوع من “الاندماج الهامشي” في هياكلها.
فقبل عدة عقود من ظهور الهجرة “غير النظامية” إلى أوروبا، كانت هذه الهجرة موجودة بالفعل وبصفة مهمة في الصحراء والمغرب الكبير.
توفّر هجرة جنوب الصحراء منذ السبعينيات الغالبية العظمى من القوى العاملة في جميع القطاعات في المناطق الصحراوية من المغرب الكبير، ذات الكثافة السكانية المنخفضة في ذلك الوقت.
لكنها أضحت أساسية بسبب ثرواتها المعدنية (النفط، الحديد، الفوسفاط، الذهب، اليورانيوم) وعمقها الاستراتيجي.
لذلك، شهدت هذه المناطق نمواً وتحضرًّا استثنائيين بدفع من هذه الدول الحريصة على التحكم في أقاليم أصبحت استراتيجية، وهي في كثير من الأحيان موضع نزاعات.
وانتشرت هذه الهجرة في جميع أنحاء منطقة الساحل مع تطور المناطق الصحراوية وفك عزلتها، حيث ظهرت في نهاية المطاف أقطاب حضرية وإنمائية مهمة، بناها أساسًا مواطنو دول جنوب الصحراء.
إنهم يقيمون فيها، وعندما لا يكونون الأغلبية، فإنهم يشكلون أقليات مهمة جدًا، ما يجعل من هذه المدن الصحراوية “أبراج بابل” إفريقية.
انطلاقًا من هذا الوعاء الصحراوي، انتشرت هذه الهجرة تدريجيًّا إلى الشمال – مع بقاء الغالبية في الصحراء -، وذلك حتى المدن الساحلية، حيث تم دمجها في جميع القطاعات دون استثناء، من الخدمات إلى الزراعة والعمل المنزلي، مرورًا بالبناء.
ويعرف هذا القطاع بالفعل توسّعًا سريعًا، كما يواجه نقصًا شاملاً في العمالة المؤهلة، بالإضافة إلى حالات نُدرة عرضيّة أو محليّة، وفقًا للفرص المتاحة في ورشات البناء.
وتلجأ شركاته الصغرى لأفارقة جنوب الصحراء على وجه الخصوص، لتمتع كثير منهم بالمؤهلات المطلوبة. ينطبق الشيء نفسه على الزراعة، ذات النشاط الموسمي جزئيًّا، بينما يشهد الريف إفراغًا في هذا المغرب الكبير الذي أصبح أكثر فأكثر تحضّرًا.
تناقض وازدواجية
تتعامل سلطات البلدان المغاربية بازدواجية مع هجرة العمالة التي يتم التسامح معها، بل والمطلوبة حتى، ولكنها غير مٌعترف بها أبدًا، وتُترك في حالة من عدم الاستقرار.
ونجد هذه العمالة في أعالي الجزائر العاصمة، حيث تقوم ببناء فيلات الوافدين الجدد إلى صف “النومنكلاتورا”، ولكنها تتعرض هناك أيضا لحملات اعتقال.
كما تشغّل العائلات المغاربية الثرية العمالة المنزلية الإفريقية السوداء، والتي يتم اختيارها لفرنكوفونيتها، وهو الوسم الثقافي للنخب الحاكمة.
نجدها أيضًا في الحوض الجزائري-التونسي للصحراء السفلى، حيث تُزرع تمور “دقلة النور” الثمينة، وتُصدّرها مجموعات غذائية قوية.
وفي القلب النابض للسياحة المغربية في مراكش ومناطقها الخلفية، وفي المساحات المسقية المغربية الموجهة للتصدير. وفي نواديبو، قلب وعاصمة الاقتصاد الموريتاني، حيث تشكّل ثلث السكان.
وفي الصحراء، ذلك الهاجس الإقليمي لجميع الأنظمة المغاربية، في أقطاب التحضر والتنمية تلك التي تصوّرها كل بلاد من البلدان المغاربية على أنها مراكز متقدمة لقوميّتها، ولكنها للمفارقة تدين بقدرتها على البقاء لوجود قوي لسكان دول جنوب الصحراء.
ففي ليبيا، التي يعتمد اقتصادها الريعي كليًّا على الهجرة، تمّ دائمًا وبشكل صريح استدراج سكان جنوب الصحراء، ومع ذلك يتم وصمهم بشكل دائم وطردهم بانتظام.
وأخيرًا، نجد هؤلاء المهاجرين من بين آلاف الطلاب من جنوب الصحراء الذين استهدفتهم سوق التعليم العالي لا سيما في المغرب وتونس، والذين يتقنون الفرنسية أو الإنكليزية بشكل جيّد، ليتم تشغيلهم في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمحاسبة في القطاع الوطني الخاص، أو الشركات متعددة الجنسيات ومراكز الاتصال.
رهان وطني
بين الاعتراف بفائدتهم ورفض قبول تسوية دائمة لوضع هؤلاء السكان، تتأرجح السلطات المغاربية بين فترات من التسامح والقمع، أو العمل على إبقائهم في مناطق الهامش، في الصحراء.
إن إنكار واقع الهجرة من جنوب الصحراء من قبل البلدان المغاربية لا يُفسّر فقط برفض هذه الأنظمة منح هؤلاء حقوقًا قانونية واجتماعية ستكون إلزاميّة في حال تم الاعتراف بهم، ولا يُفسّر باعتبارات اقتصادية، خاصة وأن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لا تزال محكومة بالقطاع غير الرسمي في المغرب الكبير.
بل يعود كذلك هذا الإنكار إلى الحاجة إلى مواجهة رغبة أوروبا في جعل البلدان المغاربية تتولّى بدلاً عنها الوظائف البوليسية والإنسانية لاستقبال وتنظيم جزء من المنفيين الذين لم تكن البلدان المغاربية وجهتهم.
لكن السبب الحقيقي الأهم يتمثّل في رغبة هذه الأنظمة في تجنب إثارة مسألة وجود هؤلاء المهاجرين على الصعيد القانوني. وينطبق هذا بشكل أكبر على اللاجئين وطالبي اللجوء.
فالاعتراف بحقوقٍ للاجئين – وعلى الخصوص الاعتراف بوجودهم باسم حقوق الإنسان – يطرح في حدّ ذاته مسألة هذه الحقوق، والتي هي غالبًا غير مُعترف بها في الإطار الوطني.
لقد وقّعت جميع البلدان المغاربية على اتفاقية جنيف، واستضافت فروعًا محليّة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكن لم يرغب أي منها في الاعتراف بهذه الصفة للمهاجرين من جنوب الصحراء، مع أنهم تحصلوا على صفة “لاجئ” من نفس هذه الفروع.
في 2013، بين ضغط المجتمع المدني الذي حفّزته حركة “20 فبراير” ورغبة القصر في دفع نفوذه في أفريقيا للحصول على دعم لموقفه من الصحراء الغربية، أصدر المغرب قانونًا سمح مؤقّتًا بتسوية أوضاع بضع عشرات الآلاف من المهاجرين.
وكان من المقرّر أن يؤدي ذلك إلى إصدار قانون وطني حول حق اللجوء، لكن هذا النص لم ير النور في نهاية المطاف.
إذ من شأن هذا الوضع القانوني – اللجوء – القائم على مبدأ حماية حرية الرأي من الاضطهاد، أن يحمي أيضًا المواطنين المغاربيين أنفسهم.
بيد أن غيابه هو الذي سمح لتونس بتسليم المعارض سليمان بوحفص إلى الجزائر، على الرغم من وضعه كلاجئ معترف به من قبل الفرع المحلي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وهي الفجوة نفسها التي تهدّد الجزائري زكي حناش بنفس المصير.
للباحث علي بن ساعد أستاذ جامعة، المعهد الفرنسي للجغرافية السياسية، جامعة باريس.
نقلا عن موقع (أوريان21).