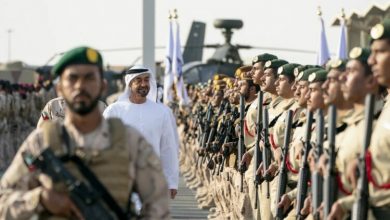رياح عاتية تهب على المسلمين في فرنسا

في فرنسا تُوصف أي مبادرة نابعة عن المسلمين على أنها طائفية ومنافية لحرية التعبير أو العلمانية، أو على أنها مظهر من مظاهر الإسلام السياسي.
وهكذا، تعرضت مساجد وجماعات إنسانية وجمعيات للدفاع عن الحقوق، ومدارس ودور نشر، ونوادي رياضية، بل وحتى مجرد محلات بيع الوجبات الخفيفة، إلى الحل أو الغلق -أو هي حاليّا موضوع هذه الإجراءات.
سهّل هذا القمع الشامل اعتماد قانون مكافحة “الانفصالية” في أغسطس/آب 2021 والذي أعيدت تسميته آنذاك بقانون “تعزيز المبادئ الجمهورية”.
رُغم عدم تجانس المستهدفين بهذه العمليات والذرائع القانونية التي يُستنَد إليها لحلّ الجمعيات أو إغلاق بعض الأماكن، لم يبق أي مجال للشك في دوافع القمع الجاري، وهي ردع أي خطاب ناقد ينبع عن المسلمين، والرغبة المعلنة والدائمة في تحييد الفضاء العام.
على سبيل المثال، أعرب وزير الداخلية جيرالد دارمانان عن ارتياحه لتجميد أصول حوالي 200 جمعية “قريبة من الحركة الانفصالية” دون أن يكلّف نفسه أن يفسّر المقصود بهذا “القرب”.
هكذا يتم إخماد الأصوات المسلمة باسم حماية حرية التعبير، بينما يتم تنظيم الانفصال وتسييس كل حدث مرتبط بالإسلام باسم مكافحة “الانفصالية” و“الإسلام السياسي”.
تكميم الأفواه
يحتل موضوع حرية التعبير مكانة مركزية في النظام الخطابي لرهاب الإسلام، إذ يتم تصوير المسلمين و“المتواطئين” معهم على أنهم يشكلون التهديد الرئيسي لهذه الحرية، ويُتهمون باستمرار بأنهم يعملون على منع أي نقاش حول دينهم.
بل ويتم رفض مصطلح رهاب الاسلام (الإسلاموفوبيا) بشدة، ويُنظر إليه من بعض الأطراف على أنه محاولة لفرض الرقابة. أقل ما يمكننا قوله هو أن هذه الرقابة تعمل بشكل سيّء.
وعلى العكس من ذلك، يكشف الحضور الدائم لموضوع الإسلام والمسلمين في النقاش العام، والحملة الرئاسية الحالية، التهميش السياسي لأولئك الذين يتم تقديمهم على أنهم تهديد للتعددية الديمقراطية.
والمفارقة أنه يتم التحدث باستمرار عن المسلمين في وسائل الإعلام الرئيسية، وفي نفس الوقت تكرار بأنه لا يمكن التحدث عنهم أبدًا.
لوقت طويل شكّلت قضية الرسوم الكاريكاتورية و“التجديف” -أي سبّ أو الاستهزاء من رموز الإسلام- نقطة جوهرية لما وُصف بإرادة في تقييد النقاش العام. وإذا كان الجدال مطروحًا قبل ذلك، فإن مَذْبَحَة جريدة “شارلي إيبدو” واغتيال المعلم صامويل باتي جعلا تناول هذا الموضوع أكثر حساسية.
ومع ذلك، فإن القول بأن تعبير المسلمات والمسلمين عن رفضهم لرسومات يعتبرونها مهينة يشكّل في حد ذاته مساسًا بحرية التعبير يُعدّ تناسيًا لكون التعبير السلمي لهذا الرفض يدخل ضمن حرية التعبير نفسها.
بينما ازداد التمييز الحكومي حدّة منذ خريف عام 2020، تبقى إدانة هذا القمع موصومة. فالحديث عن رُهاب الإسلام، وخاصة عن إسلاموفوبيا الدولة، لم يعد مسألة حرية تعبير، بل حالة من “الانفصالية الإسلامية” الذي يرتقي إلى مستوى التهديد الرئيسي للجمهورية.
يلوم على الخصوص المرسوم القاضي بحلّ جمعية “التنسيق ضد العنصرية ورهاب الإسلام” الصادر في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021 هذا التنظيم بأنه “يعمل بنشاط، خاصة من خلال الشبكات الاجتماعية، لزرع الشك في وجود رهاب الإسلام في المجتمع الفرنسي”.
من جانبه، ينص ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا -وهو نص سياسي لا مثيل له في الديانات الأخرى، يتعين على المسؤولين عن المساجد توقيعه تحت طائلة إجراءات ردعية إدارية مختلفة- على ما يلي:
غالبًا ما يكون مسلمو فرنسا ورموز هذه العقيدة أهدافًا لأعمال عدائية. هذه الأفعال من صنع أقلية متطرفة لا ينبغي الخلط بينها وبين الدولة أو الشعب الفرنسي.
لذلك، فإن شجب عنصرية مزعومة للدولة، وتقمّص موقف الضحية، يُعدّ تشهيرًا، ويغذّي ويؤجج في نفس الوقت الكراهية ضد المسلمين وضد فرنسا. (المادة 9)
فضلا عن حصر الخطاب الإسلامي من خلال تعريف غريب لما يميّز جريمة التشهير، يقوم النص بعكس العلاقة السببية بين ظاهرة رهاب الإسلام وبين نقدها. فمن خلال إدانتهم لرهاب الإسلام، يكون المسلمون مسؤولين عن الاستياء ضد فرنسا وعن العنصرية التي يتعرضون لها.
تنظيم الانفصال
يميل أيضا قانون “تعزيز المبادئ الجمهورية” -والمعروف أكثر بقانون “مكافحة الانفصال”- إلى إعاقة قدرة المسلمين على ممارسة حياتهم الاجتماعية على أكمل وجه.
هذا النص ذو هدف قمعي أساسا (وقد أقرّ بذلك مجلس الدولة في رأيه الصادر في 9 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ويُعتبر انتهاكًا واضحًا لحقوق وحريات الأقلية المسلمة في فرنسا -وهي الأكثر عددًا في أوروبا-، لا سيما تلك المتعلقة بتكوين الجمعيات وممارسة الشعائر الدينية.
ولكي نفهم روح هذا النص، يجب العودة إلى الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2020، حيث يقوم رئيس للجمهورية خلال فترة حكمه بالتدقيق في مظاهر الحياة الاجتماعية (العمل، أوقات الفراغ، التعليم، تنظيم وممارسة العبادة، الخ) لأقلية من النسيج الوطني.
يُؤوِّل الرئيس-السوسيولوجي الحالي كل مشاركة لأفراد الأقلية المسلمة في الحياة المحلية والجمعوية على أنها مظهر من مظاهر “الانزواء المجتمعي” (أو الانفصالية الإسلامية) ومشروع غزو ليسهّل دخول الإسلاموين في نسيج المجتمع:
وهناك في هذه الإسلاموية الراديكالية -بما أنها جوهر الموضوع فلنتناوله ونسميه- هناك إرادة مؤكدة ومعلنة، وتنظيم منهجي لمخالفة قوانين الجمهورية وخلق نظام مواز، وإقامة قيم أخرى، وتطوير تنظيم آخر للمجتمع، انفصالي في البداية، ولكن هدفه النهائي السيطرة، سيطرة كاملة هذه المرة.
“بين الإرهاب واللاشيء، ليس هناك لا شيء”، هذا ما قاله دارمانان في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 خلال ندوة حول “الانفصالية” بمقر وزارة الداخلية أمام أكثر من 450 من كبار مسئولي الدولة.
ويمكن أن يستهدف هذا الـ“لا شيء” أنشطة عادية مثل ممارسة الرياضة، وإنشاء جمعية، وتنظيم دروس اللغة، وفتح مُصلّى، بل وحتى متجر لبيع المشروبات.
معجم حربي
يشكّل المسلمون -الذين يعود حضورهم بشكل ملحوظ في فرنسا إلى نهاية القرن التاسع عشر- أكبر أقلية دينية منذ نهاية السبعينيات. وقد اندمجوا في المجتمع، وأصبحوا في الغالب فرنسيين وظلوا مسلمين.
هنا تكمن الفضيحة. فعندما لا تنجح الهياكل الاجتماعية وحدها في ضبط الانتماء الإسلامي، عندما يصعب التمييز بين أولئك الذين لا يمكثون في مكانهم ويتصرفون كأنهم يشبهون الآخرين، يُحتمى بالقانون لإعادة فرض النظام وحقن الغيرية وتنظيم الانفصال.
وتكمن المفارقة في أن النظام التأديبي المسخّر بأكمله ضد الأشخاص المسلمين يشهد على اندماجهم. فعمليات التفتيش وحلّ الجمعيات، وإغلاق المدارس والمساجد، وتشييد آلية تشريعية استثنائية ضد المسلمين، كل هذه التدابير تهدف إلى تنظيم الانفصال وفك العنصر الإسلامي من الجسم الاجتماعي. فرهاب الإسلام هو حقا ردّة فعل تجاه قدرة المسلمين على التحرّك.
يعجّ الخطاب الرئاسي لأكتوبر/تشرين الأول 2020 بالمفردات الحربية، ويتحدث عن “التعبئة الكبرى” و“الوطنية الجمهورية” ضد العدو الانفصالي.
كما أن هناك حديث عن الميدان والمعركة وإعادة الغزو (هكذا). هنا تظهر فاعلية الخطاب عن الإسلام والمرأة المسلمة، فهو خطاب حزم وتصميم، يسمح لمن يلقيه بالارتقاء فوق الانقسامات الحزبية إلى مستوى الخطر الداهم الذي يواجه الأمة.
ومن خلال تكرار الحديث عن مجال هذا التهديد، واستحضار “انعدام الأمن الثقافي”، ووصف المسألة بالـ“وجودية”، يدرك إيمانويل ماكرون جيدًا أن هذا الخطاب الدرامي يمنحه مكانة سيادية خاصة.
يجب تحليل العنصرية التآمرية المعادية للإسلام في هذا الإطار، وهي عنصرية تختلف عن الأشكال البيولوجية والثقافية للعنصرية.
فهي تأخذ الشكل المخيف لمؤامرة إسلامية ضد الجمهورية وأوروبا وحتى الحضارة الغربية، وقيمها التي توصف بأنها أساسية: الحرية، والديمقراطية، والتسامح، والعلمانية، والمساواة بين الرجل والمرأة، إلخ. تهديد متعدد الأوجه يستدعي بدوره مهمة طويلة الأمد للدفاع عن الوطن والعناصر التي تشكله.
تعمل الحبكة الحكومية من الأعلى على تسييس تسلطي لصورة إسلام غازٍ يشن حربا شاملة ضدنا، وتقوم باستمرار بتجديد هذا الخطاب. هنا، كل حياد محظور.
ويوصف المسلمون الذين يرفضون التنديد بهذه “المؤامرة” بـ “الإسلامويين”، أما الآخرون فيُنعتون بـ “الإسلامويين اليساريين”. وهكذا تحتل فزّاعة الإسلام السياسي، الذي يتم الخلط بينه وبين ما يُرى من الإسلام كظاهرة اجتماعية-، مكانة مركزية في هذه الرواية التآمرية.
إذ يتم تفسير كل علامة تُعتبر إسلامية على أنها “إشارة ضعيفة” (عن تطرف ما)، أو مظهر مخادع مموه لمشروع غزو سياسي للفضاء العام، وبالتالي للبلد كله.
هذا ما يفسر كيف وصف الوزير الأول -في ذروة الجدل حول “البوركيني” في صيف 2016- بدلة السباحة تلك على أنها “اختبار للجمهورية”.
كما أصبح حجاب المرأة المسلمة (من الطالبات إلى الأمهات المصاحبات لأبنائهن في المدارس مرورا بلاعبات كرة القدم) مُسيَّسا باستمرار، ويتم ربطه بشكل من أشكال التفوق الإسلامي.
ومن هنا تأتي هذه المفارقة الواضحة، حيث تخضع أي مسألة متعلقة بالإسلام في فرنسا إلى تسييس فوري بذريعة محاربة الإسلام السياسي.
تكتب فارين بارفيز في دراسة مقارنة لظاهرة رهاب الإسلام في فرنسا والهند: “تشكّل مراقبة الإسلام وتسييسه خلفية الحياة الدينية اليومية للمسلمين في فرنسا”. وتنطلق سياسة المراقبة هذه من فرضية أن الورع الإسلامي ينطوي على مخاطر سياسية جسيمة على الدولة والمجتمع. وتُعتبر البيانات الحكومية إنجازية، بمعنى أنها تخلق التهديد الذي تقف ضده.
من خلال إلغاء عدد من الضمانات التي تحمي نوعا ما المسلمين من التعسف السياسي، وإجبارهم على اتخاذ موقف دفاعي، تولّد كل هذه الإجراءات التسلطية الغضب والإحباط. ونحن نعلم كيف يمكن أن يُستعمل هذا الغضب، الذي لا يجد مساحات ليُعبّر فيها ويُسمع، وكيف يتم توظيفه لأغراض رهيبة.